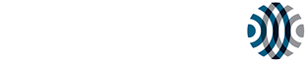تُعد القمم بين قادة الدول محاولات جريئة لتحقيق حلول جذرية. وعادةً ما يتم تقييمها بناءً على مدى نجاحها في حل قضية دولية عالقة. لكن في بعض الأحيان، يكون أثرها الأهم على الوضع السياسي الداخلي لأحد أو كلا المشاركين في القمة. ولقاء الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الشهر الماضي مثال على ذلك: فقد عزز موقف بوتين، ما ساهم في إطالة أمد الحرب في أوكرانيا واستمرار سيطرته على السلطة.
يشبه لقاء أنشارج القمة التي عقدت عام 1986 بين الرئيس رونالد ريغان وقائد الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في ريكيافيك، أيسلندا. فكما في الماضي، اجتمع قائد أميركي وقائد روسي لحل تحدي سياسي خارجي عام 1986، إنهاء سباق التسلح، وفي الشهر الماضي، إنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي كلا الحالتين، فشلا. انهارت المفاوضات في أيسلندا عندما رفض ريغان التخلي عن مبادرة الدفاع الاستراتيجية، وهي برنامج مقترح لتدمير الصواريخ النووية السوفيتية قبل وصولها إلى أهدافها. وانتهت قمة ألاسكا دون اتفاق لوقف الغزو الروسي. لكن هنا تختلف الأمور.
قد تكون لقاءتا القمة لهما عواقب بعيدة المدى على الكرملين، لكن العواقب كانت مختلفة تماماً. بالنسبة لغورباتشوف، ساهمت قمة أيسلندا في إضعاف موقفه، وعاد إلى الكرملين ضعيفاً بعد فشله في إيقاف برنامج ريغان، وكانت قراراته اللاحقة سبباً في انهيار الاتحاد السوفيتي بعد خمس سنوات.
أما بوتين، فقد خرج منتصراً. لقد رحب ترامب بالرئيس الروسي بحفاوة، وتحدث بإطراء عن "علاقتهما الرائعة". لم يُقدم بوتين على أي تنازلات، بينما نقل ترامب مسؤولية إنهاء المعارك إلى أوكرانيا، قائلاً في مقابلة مع فوكس نيوز: "الآن، الأمر متروك بالكامل للرئيس زيلينسكي لحل هذه الأزمة". وعلى الرغم من عدم مواجهة بوتين أي معارضة قوية قبل قمة ألاسكا، إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً، ويبدو أنه نجح في التأثير على الرئيس الأميركي. ووفقاً لاستطلاع للرأي أجراه مركز ليڤادا الروسي المستقل أواخر أغسطس، اعتبر 79% من الروس أن القمة كانت نجاحاً لبوتين، كما أعرب 51% عن تفاؤلهم بتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة.
بعد انتهاء القمة، لم تضطر وسائل الإعلام الروسية إلى نشر أخبار مزيفة لتسليط الضوء على هذا النجاح الدبلوماسي لبوتين، بل تناولت الحدث كما هو، مع تعليقات إعلامية غربية حول انتصار بوتين. وبذلك، أصبح بوتين أقوى من أي وقت مضى، ويمكنه مواصلة الحرب ضد أوكرانيا حتى تحقيق هدفه.
نهاية محتومة لإمبراطورية
عندما اختار المكتب السياسي غورباتشوف أميناً عاماً للحزب الشيوعي السوفيتي عام 1985، كان الوضع في البلاد يتطلب إصلاحات جذرية. كان الجيش السوفيتي متورطاً في حرب أفغانستان، التي وصفها غورباتشوف بـ"النزيف المستمر"، وكان التخطيط الاقتصادي المركزي الفاشل يعيق النمو الاقتصادي للاتحاد السوفيتي. كما أن تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة، الذي استمر من أواخر الستينيات إلى أواخر السبعينيات، لم ينجح في تخفيف التنافس بين القوتين العظميين. وكان الفساد والفقر والبيروقراطية منتشرة على نطاق واسع.
وعد غورباتشوف كل من المتشددين والإصلاحيين بحل هذه المشاكل. لكنه لم يعد بحل جذري للنظام السوفيتي، بل قال إنه سيحقق النجاح برفع الإنتاجية وتقليل النفقات. طمأن النخبة السوفيتية بأن الحزب الشيوعي سيبقى قوياً ومتسيداً. بدلاً من تغيير سيطرة الحزب، سعى إلى تعزيز العلاقات مع الغرب، مما يسمح لموسكو بتقليص الإنفاق العسكري وتعزيز التحديث الاقتصادي. لذلك، طلب غورباتشوف من المكتب السياسي دعم المفاوضات مع واشنطن لتقليص ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية. وافقت النخبة الأمنية السوفيتية على الاتفاق، شريطة أن تتنازل الولايات المتحدة عن أنظمة الدفاع الصاروخي. وحذروا من أن أي اتفاق لا يحقق هذا الشرط سيؤدي إلى تفضيل واشنطن.
لهذا السبب توجه غورباتشوف إلى أيسلندا: ليثبت للعالم ولزملائه في الحزب أن بإمكانه إنهاء سباق التسلح وإحياء الاقتصاد السوفيتي. لكنه فشل فشلاً ذريعاً. شاهد العالم عبر التلفاز ريغان يرفض إلغاء مبادرة الدفاع الاستراتيجي، وغورباتشوف يعود خالي الوفاض. عند عودته إلى موسكو، اضطر إلى الدفاع عن نفسه أمام المكتب السياسي المتشعب، حيث واصل المحافظون المطالبة بإلغاء أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية. واجه غورباتشوف قيادة منقسمة.
في النهاية، اختار الاعتماد على أنصاره الإصلاحيين لحماية منصبه. ففي عام 1987، وافق غورباتشوف على معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى مع ريغان، رغم أنها لم تقيد أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية. أقصى غورباتشوف المحافظين في المكتب السياسي، وبدأ يعتمد أكثر على القادة والمستشارين المعتدلين، لاسيما وزير الخارجية السوفيتي إدوارد شيفاردنادزه. وفي السنوات التالية، نفذ غورباتشوف سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الشاملة سمحت بإنشاء مشاريع تجارية شبه خاصة، ومنحت مزيداً من الاستقلالية للجمهوريات الخمس عشرة التي كانت تشكل الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك روسيا. لكن بدل إطلاق ديناميكية اقتصادية تُسكت معارضيه، أدت إصلاحات غورباتشوف إلى انهيار النظام السوفيتي من دون إنشاء نظام جديد فعال. ازدادت طوابير الانتظار لشراء المواد الغذائية، وعاشت المدن السوفيتية اضطرابات بسبب المجاعة، وبدأ تأخر دفع الرواتب.
وفي محاولته الحفاظ على سلطته، دمر غورباتشوف البنية التي كانت أساسها. وبإضعافه أساليب السيطرة السياسية السوفيتية، فتح المجال أمام الحركات والقادة القوميين، ومنهم بوريس يلتسين في روسيا، ليقووا شوكتهم. ونتيجة لذلك، استطاعت هذه الحركات السيطرة على ما تبقى من الدولة المتداعية. وفي ديسمبر 1991، انتهى الاتحاد السوفيتي.
مع عامل الزمن في صفه
روسيا بوتين ليست الاتحاد السوفيتي في عهد غورباتشوف. لا يوجد قيادة جماعية تمنع الكرملين من اتخاذ قراراته. لا يخضع بوتين لأي مكتب سياسي أو لجنة مؤثرة: فهو يحكم نظاماً استبدادياً شخصياً، حيث هو المصدر الوحيد للسلطة. ويعود وضع المسؤولين ورجال الأعمال في دائرة بوتين، ونفوذهم وثروتهم، إلى ولائهم وخدمتهم له فقط. لكن هذا لا يعني أنه بمنأى عن الخطر. فالدعاية الحكومية الروسية قوية، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة قد تُثير عدم الرضا في المجتمع الروسي. ومن غير الواضح كيف ستكون ردة فعل النخبة الروسية إذا اضطر بوتين إلى تقليص امتيازاتهم الاقتصادية.
حتى الآن، نجح الرئيس في إدارة هذه المخاطر. فبعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب، لم ينهر الاقتصاد الروسي تحت وطأة العقوبات. بل نجح القادة الاقتصاديون الروس في الحفاظ على نمو يزيد عن 4% العام الماضي، مدعومين بالإنفاق العسكري الكبير. وظلت معدلات التوظيف والاستهلاك وإمكانية الحصول على الائتمان مرتفعة. يصعب قياس الرأي العام بدقة في دولة استبدادية، لكن لا توجد مؤشرات خارجية على أن عدم الرضا في صفوف النخبة أو المجتمع ككل يهدد حكم بوتين.
مع ذلك، أدى الإنفاق الحكومي الكبير لتعزيز الاقتصاد إلى ارتفاع التضخم، ليقترب من عشرة في المئة عام 2024، ويتجاوز ثمانية في المئة هذا العام. كما أن حرب بوتين تفرض كلفة فرصة كبيرة على روسيا. ففرض العقوبات الدولية التي تحد من تجارة البلاد واستثماراتها وإمكانية حصولها على التكنولوجيا يعيق الإنتاجية والنمو. يمكن لروسيا بيع النفط للصين والهند، لكن محدودية وصولها إلى الأسواق العالمية تجبرها على بيعه بأسعار مخفضة. يستطيع الجيش الروسي تجنيد جنود جدد بعقود، لكنه مضطر لتقديم مكافآت إضافية كبيرة وأجور أعلى لجذبهم، وهذه العقود تساهم في تفاقم نقص العمالة والتضخم.
في ألاسكا، لم يبدِ ترامب أي اعتراض على خطاب بوتين. ساعد أداء بوتين في ألاسكا في تخفيف هذه الضغوط. صحيح أنه لم يحصل على موافقة على بعض المطالب القديمة أو على الصفقات التجارية التي أشارت إليها إدارة ترامب، لكنه في نظر النخبة الروسية والشعب، حقق نجاحًا. لقد كسر عزلة الغرب عنه، وهبط في الولايات المتحدة تحديًا للعقوبات الدولية وطلبات الاعتقال بتهم جرائم حرب. لقد تأجلت العقوبات الجديدة القاسية على النفط الروسي، وربما تم تجنبها تمامًا. وأعاد التأكيد للعالم على موقف موسكو الثابت الذي يطالب بألا تقتصر تنازلات أوكرانيا على الأراضي فحسب، بل تشمل أيضًا سيادتها واستقلالها.
في الواقع، ساعدت القمة بوتين في إضفاء الشرعية على مطالب موسكو، ما منح الروس الذين قد يشككون في حكمة الغزو، سببًا للاعتقاد بأنه كان، كما وعد بوتين، مشروعًا. وفي كلمته أمام الصحافة، وبدافع "السعي إلى السلام"، تحدث بوتين عن "مخاوف روسيا المشروعة"، ورغبته في تحقيق "توازن عادل للأمن في أوروبا والعالم"، و"ضرورة إزالة كل الجذور الأساسية، والأسباب الرئيسة" للصراع في أوكرانيا. لم يبدِ ترامب أي اعتراض على هذا الخطاب. بل يبدو أنه وافق على موقف بوتين بأن لموسكو حق التدخل في سيادة أوكرانيا وضمانات الأمن الغربية. عاد بوتين إلى بلاده بعد أن أثبت لجمهوره أنه كان على حق، وأنه لا ينبغي لهم التراجع، وأنه سيحقق لهم النصر.
بالنسبة لبوتين، لم تكن القمة أبدًا عن السعي إلى السلام في أوكرانيا. هدفه كان دائمًا فرض إرادته على النظام الدولي والحفاظ على سيطرته المطلقة على السلطة في الداخل. منذ بدء تدخلاته في أوكرانيا عام 2014، كان بوتين يتبع استراتيجية طويلة الأجل. وكان يعتقد دائماً أن الوقت في صالحه. وقد منحته قمة ألاسكا مزيداً من الوقت، كما عززت موقفه في سبيل تحقيق النصر العسكري.